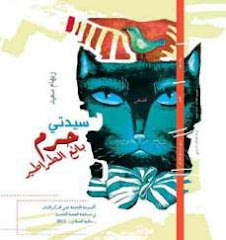أعتقد بأن صاحب الفرن قد حفظني..
في كل يوم فيما بين التاسعة و النصف، و العاشرة و النصف أشتري باتيه سوسيز بـ 3 جنيه من أجل الإفطار.. ثم أعبر الشارع إلى صاحب السوبر ماركت الطيب الذي يساعدني في التخلص من الأوراق النقدية المهترئة التي أخشى عدم التمكن من صرفها أبداً.. فأشتري عصير أو زجاجة مياه أو كرت شحن بـ 10، فيصرفها لي بابتسامة، أظنه حفظني أيضاً
ثم أن معظم سائقي ميكروباصات التحرير قد حفظوا شكلي تقريباً، الفتاة التي تضع السماعات دائماً و أبداً و ترتدي ملابس تحوي ورداً في أي قطعة منها و تجلس إلى جانب أي شباك لتقوم بتناول وليمة إفطارها بنهم، ثم تحدث جلبة ملحوظة بكرمشات الأكياس و فتافيت الخبز...
أما عن بائع جرائد موقف عبد المنعم رياض فلقد حفظني بالتأكيد و تأكّد تماماً أنني لن أشتري منه الجرائد ما حييت.. غير أني أقف كل صباح أمامه أتصفح كل العناوين بتوتر واضح قبل أن أغادر حيث ميكروباصات المهندسين، حيث التبّاع صاحب الذراع الواحدة الذي أرغب في تصوير ابتسامته إذا ما امتلكت كاميرا جيدة قريباً، التباع الذي حفظني أيضاً لدرجة أنه استوقفني في أحد الأيام قبل أن أرتكب غلطة فادحة قائلاً بابتسامة شاسعة: " بتعملي ايه عند ميكروباصات امبابة؟" فأنقذني من ساعة أو أكثر من التوهة و التأخير عن الشغل..
ثم أن أمن عمارة الشغل حفظني تماماً و أصبح يناديني" باشمهندسة" أخيراً بعد سنة كاملة من التعيين.. و يعلم أنني دائماً مستعجلة و متأخرة و ألقي سلامي الصباحي دون أن أنتظر الجواب لأنني لن أسمعه بسبب السماعات على أية حال..
لم يحفظني أحد في الميدان بعد.. لا أستطيع الذهاب سوى تخاطيف و لا أتحمل الغاز لمدة تزيد عن الدقيقتين.. لا أقتنع بدوري الثوري في الجلوس في أحد تكتلات أصدقائي لأنني لن أستطيع الاعتصام و لا أملك سوى ساعتين كحد أقصى داخل إطار الحدث، فأفعل كل شيء تخاطيف.. أنضم لمسيرة أو اثنتين تخاطيف، أهتف تخاطيف، أبتاع بضعة محاليل ملحية تخاطيف، و معمول بالعجوة أحاول إعطاؤه للخارجين من شارع محمد محمود لربما ساعدتهم نسبة السكريات في الدم و لا حاجة! أو أكنس الميدان و أتحمل يوماً كاملاً في الشغل من التفنن في التريقة على ذلك لأنني غبية و حكيت ذلك بفخر...ثم أعود للبيت منهكة تماماً من هذه المهام الصغيرة جداً، فأقوم بتشيير بضعة صور و تعليقات أسخر فيها من كل شيء و أقنع نفسي بأنني أساعد هكذا في فضح ولاد الكلب.. أنام بملابسي، ربما بحذائي أيضاً نتاج الإنهاك.. و أستيقظ بعينين متورمتين و رغبة في استكمال مساراتي الضئيلة، دون مضايقة أحد أو الغرق في التبرير..
بالأمس بعد أن غادرت الميدان ، راقبت من شباك الميكروباص ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم مابين الخامسة و الثامنة.. يجلسون في مقابلة الزجاج الخلفي لسيارة 28 منهكة يقودها أب بوجه مقتضب و أم تحاول مراقبة الشارع في الاتجاه الآخر بغربة واضحة... و لكن أفواه الصغار كانت تتحرك بانتظام يوحي بأنهم ينشدون أغنية ما.. و تتوقف أصغرهم فجأة و تضحك بلا سبب ثم تكمل معهم الاسترسال في غناء يحجبه عني الزجاج و لا يظهر لي منه سوى هز الرؤوس الصغيرة بتمايل مع اللحن الخفي..
في موقف كهذا عادةً كنت سأفكر في صغاري أنا التي سأنجبها من الشخص الذي أحب.. و كيف أنني في موقف كهذا كنت سأشاركهم الغناء بالطبع و التمايل و الضحك بأعلى صوت .. و لكن لم يخطر في بالي هذه المرة سوى فكرة واحدة : معانا حق! و المصحف معانا حق.. لسنا مجموعة من الشباب الطائش الذي سيدرك بعد مدة أن الفترة الحالية كانت تستلزم حكمة من نوع آخر و حقناً لكل هذه الدماء.. ربما تمنينا ببلاهة أن تظل هذه الصغار آمنة... أن تملك حقوقاُ أرهقتنا في الاختيار و الحب و البغض و الفهم.. و الاستمتاع بتفاصيل حياة لم يُعدّها أحدهم مسبقاً...
أغمضت عيني في إنهاك لبقية الطريق، حيث أنه من المحفوظات أيضاً أن أعود للبيت منهكة و خائفة من كل شيء ..
لعبة wait & see!